د.أيّوب أبو ديّة - لماذا يبحث د.سميح مسعود في كتابه «حيفا.. برقة» الذي صدر مؤخراً عن دار الفارابي في بيروت، عن جذوره في برقة وحيفا، هل لأنه فلسطيني فقد منزله ووطنه ولم يتبق له سوى الذكريات؟ ولكن، ألسنا كلنا نبحث عن جذورنا في داخل أوطاننا؟ فهل هي تركيبتنا الجينية التي تستنفر مشاعرنا وأحاسيسنا للبحث عن الجذور، ربما لغرض معين أو غاية ما؟
كم كان مقدار امتنان المؤلف لحسناء الدراوشة التي عرّفته إلى جذوره لدرجة أنه أهداها سيرة حياته! والكاتب يعترف قائلاً: إنها مجرد «محاولة غريزية أريد بها أن أنثر بذور جذوري لأحفادي حتى لا يضيعوا في مضارب الشتات القصية» (ص 14). ولكن، لماذا يضيع أطفاله وهم في وطن جديد (كندا) يقدم لهم جميع الحقوق إذا قاموا بتأدية جميع الواجبات، أليست كندا أفضل من حكم العرب للعرب؟
بالرغم من ذلك، تظل حيفا أولاً، وقبل قريته برقة أيضاً بالرغم من أنه ولد فيها، إذ يُستهل حديث الكاتب بحيفا بوصفها مركزاً تجارياً واقتصادياً وبحرياً مهماً، وحيث الخط الحديدي الذي كان يربط الأردن والعراق وسوريا بالبحر المتوسط، وحيث أنبوب النفط القادم من كركوك يصب في مستودعات شركة نفط العراق (ipc)، وحيث الشواطئ الجميلة وجبل الكرمل بانعطافات سفوحه وبساتينه الخلابة.
لا يوثق الكاتب سيرة حياته في هذا الكتاب بقدر ما يوثق سيرة حياة حيفا وأهلها ونواديها الرياضية (وبخاصة كرة القدم) والثقافية والنقابية والفنية، وبقدر ما يوثق أبنيتها وبساتينها وشوارعها ومقاهيها وأحياءَها العربية واليهودية ونفوذ الاحتلال الإنجليزي ومحاباته اليهود.
وُلد الكاتب في نهاية العام الثاني لثورة 1936 التي أخذت تنداح مدىً إلى أن وضعت بداية الحرب العالمية الثانية لها نهاية سريعة، لكن شهداء الثورة ظلوا في الذاكرة ومنهم من أُطلق اسمه على شوارع عمّان، مثل ابن عم والدة كاتبنا: الشهيد عبد الرحيم الحاج محمّد الذي أُطلق اسمه على شارع مهم في الصويفية، كما يخبرنا المؤلف.
كيف يمكن لسميح مسعود أن ينسى حيفا وقد زحف على أرضها لمدة خمس سنوات وهو مشلول جزئياً قبل أن يشفى وتقام له الدبكات والميجنا والزجل والأغاني الشعبية والوطنية؛ لقد توثقت علاقته بالأرض أكثر من أيّ حيفاوي آخر، ولم ينسَ أحداً من أصدقاء والده الذي حضروا الحفلة تلك الليلة احتفاءً بشفائه، فقد دوّن والده أسماءَهم في مذكراته التي أتعجب لماذا لم يخصص لها الكاتب ملحقاً قصيراً في نهاية كتابه إحياءً لها!
تفاجأت خلال قراءة الكتاب من التنوع الهائل لسكان حيفا كما يرويها مؤلف «البحث عن الجذور»، فهم من فلسطين والأردن وسوريا ومصر وتونس والمغرب والعراق وغيرها من الدول العربية، وهم على مذاهب مختلفة: بروتستانت ولاتين ومسلمون وبهائيون ودروز في قرية عسفيا المجاورة، وهناك جاليات من الألمان واليهود والإنجليز وغيرها من الجنسيات الأخرى. هذا التنوع الهائل هو الذي أخرج عقلية كهذه، منفتحة على العالم ولا تقيس الناس إلا بمعيار الإنسانية.
ثم تصل ذاكرة المؤلف إلى «برقة» حيث عاش جده مسعود من ولاة إبراهيم باشا على وادي الشعير الشرقي، وحيث تنحدر أمه من عائلة تقلدت مشيخة وادي الشعير الشرقي في النصف الأول من القرن التاسع عشر، وحيث كان للشيخ عيسى البرقاوي مساهمة فاعلة في ثورة الفلاحين ضد إبراهيم باشا العام 1834؛ ويغرق المؤلف في وصف قرية برقة على نحو أتوقع أن يرسمها أحد الفنانين قريباً من وحي هذه الذكريات الدقيقة والممعنة في التفصيلات الشيقة، حتى يصل إلى وصف الدير الذي يجاور بيتهم مباشرة والذي كان هدية من عمه لمسيحيي برقة الفلسطينين من العرب الغساسنة لبناء دير ومدرسة على أرضه مساحتها عشرة دونمات، ثم قام على إثرها المستشفى الإنجيلي في نابلس بفتح عيادة في برقة لخدمة أهلها بمبالغ زهيدة.
انجبلت ذكريات المؤلف مع أصناف الطيور والزواحف والحيوانات وسنابل القمح والأعشاب والأشجار وعيون الماء في قريته برقة، على نحو يذكّر بفلسفة «اسبينوزا» والتوحد مع الطبيعة، ثم شرع يتعلم في مدرسة القرية عند جدته التي وجدت في ذلك العمر المتقدم من تستأنس به؛ هنيئاً لك بتلك الذاكرة المفصلة لزملائك في الابتدائية وأساتذتك منذ الصف الأول، فمن النادر جداً تذكُّر الأحداث على هذا النحو في سن السابعة، لكن الأمر يبدو أنه لم يعد يتعلق بالذاكرة الخاصة فقط، بل تجاوزها إلى المشاعر والعواطف والذاكرة الجمعية، إذ يبدو أنه ما انفك يقرأ ويستمع إلى فلان وعلان منذ ترك فلسطين.
وكانت النتيجة أنه كتب في هذا الكتاب، لا سيرة حياته وحسب، بل سيرة حياة قريته «برقة» أيضاً، ووثق مفردات لغوية من الريف لأدوات تقليدية ووجبات شعبية وأدوات متنوعة تشكل في مجموعها قاموساً صغيراً للريف الفلسطيني في زمن الثورة والانتداب على نحو يذكّر بمؤلف «راهبة بلا دير» عن مدينة يافا للأستاذة نها بطشون.
وفي حيفا لم يترك مكاناً عاماً للسياحة أو لعب الكرة أو التنزه، كبساتين الخياط والانشراح، أو فرقة فنية أو موسيقية أو فيلماً كان يُعرض في السينما أو برنامجاً إذاعياً، إلا تم توثيقه وفق الأصول. حتى المناسبات الدينية كعيد مار إلياس فتح باب النقاش حوله وردّه إلى تاريخه القديم وأسباب تذكّره وإحيائه، وأوضح كيف يشترك المسلمون والمسيحيون واليهود والدروز في إحيائه سنوياً، كأنها أعياد مشتركة تُسوِّغ الحياة المشتركة بين الجميع.
يتساءَل المؤلف في أكثر من مقام عن أسباب انحسار التقدير للموروث الشعبي الإنساني عند العرب الذين لم يكونوا يميزون بين مذهب أو طائفة، لكنه لا يخوض في أسباب هذا الانحدار الثقافي والمعرفي!
وعندما يصل إلى قرار التقسيم في العام 1947، يروي المؤلف أحداثا دقيقة ومفصّلة عن تداعياتها وعن الفوضى التي حدثت بعد انهيار المقاومة العربية وانقطاع المدد ولجوء عائلته إلى قريته برقة، في حين تدافعَ السكان على الشواطئ للهروب إلى سوريا ولبنان بقوارب إنجليزية. وفي لحظة الشعور بالقهر غمرتني فجأة سعادة عظيمة عندما أشاد المؤلف بالبطل الأردني محمّد حمد الحنيطي الذي استشهد دفاعاً عن حيفا، وشعرت كأنني ساهمت شخصياً في الدفاع عن حيفا أيضاً.
تستمر رحلة المؤلف وعائلته من برقة إلى دمشق فبيروت، بحثاً عن رفاقه وأقربائه الذين توزعوا على مخيمات اللاجئين. لا شك في أن المؤلف اقتفى أثر والده في البحث عن الجذور، وأيّ مشاعر دفاقة تبحث في تلك الجذور الغائرة في التاريخ والوجدان؟
شعرت إثر قراءَتي الكتاب أنني محظوظ لعدم ابتعادي عن مكان ولادتي في عمّان، فما تزال والدتي تعيش في البيت الذي ترعرعت فيه بجبل اللويبدة، ولا أنفك عن زيارة بلدة والدي (الفحيص) حيث يعيش أقربائي وأهلي، أما مسقط رأس أمي في السلط فقريب، بل وما يزال بيت جدي الذي بُني في أربعينيات القرن الماضي بجبل الأشرفية قائماً. وقد أمضيت سنوات طويلة في بيت المزرعة في «الكمالية» الواقعة على طريق السلط، ومؤخراً أقمت منزلاً إلى جواره وأنا أرمق البيت القديم دوماً وأتخيل أحداث الستينيات ومطلع السبعينيات من القرن الماضي وما كان يدور في ذلك البيت من أحداث. كم أنا محظوظ ألا أفارق جذوري، حتى مدرستي ب «تراسانطة» شاءَت الأقدار أن يكون مكتبي مطلاً على ساحاتها لمدة ثلاثين عاماً... لكنني محظوظ لأنني قرأت كتاب د.سميح مسعود، فقد استطعت أن أعيش تجربته عبر كتابته.
يعود المؤلف إلى حيفا في سن الستين، ثم إلى برقة ويقابل سيدة من أقربائه تنقل له رسالة مفادها أن شيوخ القرية يهرمون ويموتون وتغلق بيوتهم فلا يوجد من الشباب في القرى من يشغل هذه البيوت. وأوصته العجوز بحمل الرسالة إلى رام الله.. وإلى العالم العربي وما بعده.. إلى أقاصي الأرض. إنها عودة إلى الجذور بهدف إبقاء الذاكرة الجمعية حية سياسياً واجتماعياً وثقافياً، بعيداً عن العشائرية والاقليمية والطائفية والمذهبية البغيضة. وهي عودة نقدية لما آلت إليه الأحوال، هي نقد لغياب مرجعيات قيادية وطنية واضحة، حيث غدت السلطة الفلسطينية مرتبطة ببروتوكولات باريس الاقتصادية وغارقة في البيروقراطية والمحسوبية. فالعدو من أمامكم يا صديقي ونحن من ورائكم، فأين المفر؟
إنها رواية خالدة لحيفا وبرقة ويافا وعكا والقدس وأريحا وبيسان وطبريا وقانا الجليل والناصرة وإكسال، ولكنها ليست بحثاً عن الجذور فقط، بل هي «بحث في الجذور» أيضاً، وبامتياز!
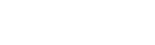




 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس

المفضلات