
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشق البتراء

من أعظم ماابتليت به الأمة الإسلامية في العصر الحديث,في عديد من أقطارها؛ فقدانها أخلاق الحيوية والنشاط, وشيوع أخلاق الضعف امتداداً لنموذج (المسلم) في عهد الانحطاط, حين عاني المجتمع في تلك الحقب, من تغلغل قيم الهبوط الفكرية: كجبن العقول عن الإبداع والاكتشاف, عندما انطمرت الحيوية والحرية, في نظام التعليم التلقيني, المعتمد على الترديد والحفظ, والجدب الفكري, وضبابية التفكير, والتناقض والبلبلة, فكثر المحفوظ والمنقول, وقل المحصول, وكثر التنظير, وقل التطبيق, وكثر الكلام وقل العمل.
ولما فسدت المفاهيم والأفكار, هبطت القيم, وتهاوى السلوك, فوئدت الحرية, وعاشت عناكب العبودية, وضمرت إرادة النجاح, وأصبحت الجبرية والاستسلام, شعار الإنسان النموذجي, وجزء الدين وحوصر في المسجد, فشاعت الرهبانية والزهد الانعزالي, على أنهما نموذج المسلم الحقيقي.
فصار الدين محصورا في العبادات الفردية والروحية, و شاع التشاؤم والقنوط, وصارت العزلة وانتظار الحل, عبر الأحلام والمنجمين والكهان, أو انتظار المهدي أو المسيح, هي أسلوب الفرار الرومانسي من تبعة الحياة, وهي البديل عن التخطيط السليم لبلوغ النجاح.
واحتقر العلماء الرأي العام, ففقدوا أعوان الخير, الذين يضغطون للإصلاح, ويهبون الفكر الحيوية والحركة, وشاعت الأنانية والفردية, وكره الناس روح الإيثار والتعاون الاجتماعي, وحصر الناس إصلاح المجتمع بالحكام, وغاب عنهم دورهم ودور المثقفين والأعيان.
وشاعت روح التخاصم والتنابذ, والعصبية القبلية والإقليمية, فتمزق السلام الاجتماعي, وتحللت القيم الإدارية, والعلاقات الحكومية والشعبية, وتهدمت البني التحتية, فشاعت في الأمة روح الهزيمة.
والمتتبع للاتجاهات الشائعة, في تلك الفترة, يجد فيها العجز والاستسلام للواقع الفاسد. ويجد الأدب الفني والاجتماعي والديني, يحتوي قيما تتواكب مع الواقع الرديء أو تصادم قوانين الاجتماع, بدلاً من مغالبتها بتدرج وتؤدة.
ويجد ذلك شائعاً في الأمثال والحكم, مثل قول ينسب للشافعي, (ولا أدري أهو له حقاً, أم أنه نسب إليه لتقوى فكرته بقوة قائله, وهو فيما يبدو لا ينسجم مع شخصيته):
دع الأيام تفعل ما تشـاء وطب نفساً بما فعل القضاء
ولا تجزع لحادثة الليـالي فليس لحادث الدنيا انقضاء
هذه الهزيمة النفسية, نتاج النزعة الجبرية, التي يرسم مبدأها شاعر آخر:
جرى قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسـكون
جنون منك أن تسعى لشيء ويرزق في مشيمته الجنين
منطق أحمق صدق به كثير من الناس, فجلسوا ينتظرون الفرج الغيبي, وهم للواقع الفاسد مستسلمون, لذلك نجد كثرة في الأدعية, وقلة في العمل, مع أن الرسول صلى الله علية وسلم نص على أن الدعاء لا يرفع, متى كان الداعي مستخذيا، لايأمر بمعروف ولاينهى عن منكر.
لأن هؤلاء الخاملين الذين يستسلمون للطغاة , ليسو ضحايا ولا مساكين، بل فساق في محكمة القرآن, كما قال تعالى عن قوم فرعون «فاستخف قومه فأطاعوا*إنهم كانوا قوما فاسقين».
لقد شاعت في ثقافتنا التراثية, منظومة الدعاء والزهد والغيبية, أسلوباً بديلا عن عمل الإنسان, ولذا نجد كثرة في نصوص الزهد, التي تدعو إلى الانصراف عن حيوية الحياة الاجتماعية, إلى التصوف والعزلة.
لقد فهم الناس القيم الأخلاقية الإسلامية, فهماً نكوصياً , فهموا الصبر على أنه التسليم بالواقع الهابط, وقبول الذلة, والرضا بالإهانة والاستكانة, وغفلوا عن جوانب الصبر الأخرى, كصبر الشجاع حين البأس, وكصبر الحليم حين الغضب. وكظم النفس, الأمارة بالسوء, وصبر الحكيم على الأذى, ونحوها من القيم التي مدح اللَّه بها عباده المؤمنين: فقال: «إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب».
ولكن هؤلاء اعتبروا أن الصبر هو التسليم بالأمر الواقع, مع أن ذلك صبر البهائم, صبر صاحبه غير مأجورإن كان غير مأزور.إلا إذا كانت المصيبة، من مالا يستطيع الناس دفعه أو منعه, فالصبر المأجور وهو الفعالية والمغالبة, في كل أمر للإنسان طاقة في دفعه أو منعه, أو التقليل من رزئه, هذا هو صبر الموقنين باللَّه, الواثقين بأنفسهم قال تعالى: «وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا*لما صبروا*وكانوا بآياتنا يوقنون» والصبر المأجور على المصائب, هو الرضا بقدر اللَّه, الذي يستثمر المؤمن فيه الإخفاق أمام المصيبة التي لا يقدر على دفعها, فيندفع إلى نجاح في مجال آخر.
مشكلة كثير من المسلمين أنهم حرفوا المفاهيم الفعالة في الإسلام, كالصبر والفقه, وتعليم القرآن, والإيمان بالقدر خيره وشره, والدين والأخلاق إلى مفاهيم خاملة. وظلوا يرددون النصوص التي تثنى على ذلك المفاهيم, دون أن يدركوا أن النصوص التي تثني تعنى مفاهيم منشطة, غير المفاهيم المتأكسدة التي رسخت في أفئدتهم. وهذا من الجهل المركب.
بذلك غفل كثير من المسلمين, عن الصورة الحية التي يرسمها الإسلام للحياة, وهي صورة لا تتحقق بمجرد قراءة القرآن الكريم تجويداً و ترتيلاً. ولا بمجرد التسبيح للَّه بكرة وأصيلا. وإنما تتحقق بترجمة القرآن إلى واقع عملي في الحياة, وبترجمة التسبيح إلى حركة عملية وجسدية, وبهذا الفهم المتحرك لوظيفة القرآن الكريم, يقرأ القرآن ويحفظ, ويصبح من تعلمه خيراً من غيره.
فالقرآن لم ينزل ليكون حجباً وتعاويذ وخطوطاً, يكتبها الأطباء الشعبيون بالزغفران, لكي تعلق على المرضى والصبيان, ولم ينزل ليكون بركة على القبور أو المآتم.
وإنما نزل ليكون حكماً يحكم به الناس, قال اللَّه تعالى: «إنّا أنزلناه حكماً عربياً لقوم يؤمنون»ومن يقرأه دون إدراك وظيفته, كالمريض الذي يكرر قراءة الوصفة الطبية, دون أن يسعى إلى الصيدلية, ويبدأ في برنامج العلاج.
ولكن كثيرا من المسلمين لم ينتبهوا إلى هذه الحقائق, ففصلوا بين الحياة الدنيا والحياة العليا, فتركوا الدنيا تسير, دون أن يهتموا بالمشاركة في إدارة دفتها, وانشغل كثير من المتدينين بالبحث عن الآخرة, دون ربط بين الدارين, يدركون به أن النجاح الجماعي في الدنيا والآخرة لا يتجزأ, وإن تجزأ النجاح الفردي.
وانتشرت الخرافات والأساطير, وضعف التفكير في الأسباب والنتائج, فضعفت الشخصية المسلمة, على مستوى الفرد والجماعة, لأن العمل بالدين قل في مجالات بناء الجماعات, وما تتطلبه من تخطيط لبلوغ الأهداف الإنسانية الخيرة, من عدل ومساواة, ومن حرية وتسامح, ومن ترتيب وانضباط وتنظيم, في الإدارة والقانون, و السياسة والاجتماع والأسرة.
عندما أهملت القيم التي تنهض بها الأمم, وقصر الدين على العبادات الخاصة; سقط السور الدفاع الخارجي وهو النظام الحضاري العمراني, فتلاه في السقوط سور الدفاع الأوسط وهو النظام المدني والاقتصادي, فتلاهما في السقوط سور الدفاع الداخلي, سور الأخلاق والقيم, فانهار قلب المبنى وهو الإيمان والأركان الإيمان والإسلام.
بدأ ذلك عندما دخلت على الناس الخرافات, التي لم ترد في الدين. ومن يقرأ أي كتاب من كتب التفسير يجد الأساطير الأسرائيلية, والنصرانية، والفارسية والعربية، وقد كسيتِ عباءة إسلامية فكونت مفاهيم فكرية وقيما وعادات اجتماعية, عند العامة والمثقفين والعلماء أيضا, وخلطت الوحي المنزل بالآراء البشرية الهشة.
تفسير كتاب الله نموذج لعقلية الأمة, وبذلك تهاوى الفكر العملي العقلاني الفعال. فانهار النظام التربوي, فأصبحت كثير من بلدان المسلمين مجتمعات ذات مدارس, ولكنها بلا تربية اجتماعية, عند ذلك انهار البناء الاقتصادي, ثم تعلق به انهيار النظام السياسي.
ولقد غفل كثير من المسلمين عن سنن اللَّه الكونية, التي ليس لها تبديل ولا تحويل,كما ذكر البارئ الجليل «ولن تجد لسنة اللَّه تحويلا. ولن تجد لسنة اللَّه تبديلا» وهذه السنة ظاهرة, في كل خلق اللَّه من أشكال الوجود, كالمادة والنبات, والحيوان والإنسان, وسنن اللَّه في خلقه تستجيب لمن يعرف كيف يستثمرها, ولو كان كافراً, كما قال اللَّه تعالى «وكلا نمدُ هؤلاء من عطاء ربك*و ما كان عطاء ربك محظوراً».
القضاء والقدر قانون من آمن به إيماناً فاعلاً, عرف أنه لا يصادر إرادة الإنسان, فسعي ونجح واستثمر الطبيعة التي سخرها الله للبشر, واستجاب له القدر إذن, هذه الحقيقة لم يبلورها مثقف, بصورتها القرآنية الفعالة, كما بلورها أبو القاسم الشابي:
إذا الشعب يوماً أراد الحياة × فلابد أن يستجيب القدر
ولكن سنن اللَّه الاجتماعية تعصى من لا يحسن استثمارها, ولو كان تقياً نقيا.
نسى أغلب المسلمين في أزمنة الهبوط, أن اللَّه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم, فاستسلموا للواقع الرديء وقبلوا به, ومن هنا جاءت كل هذه التبريرات. وما ذلك إلا بسبب اختلال منهج التربية, وهذه الأمور هي التي أنتجت مفاهيم وأفكاراً, منحت الواقع الرديء, صفة الديمومة والإطلاق وتسببت في الانهيار الحضاري.
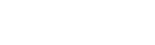



 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس



المفضلات