انتشار ظاهرة ما لا يعني الاستسلام لها، ولعلّ ظاهرة تعاطي المخدرات وتداولها أيضاً ظاهرةٌ لا ينبغي لنا الاستسلام لها ولخفافيش الظلام الذين يوجهون سمّها إلى عقر دار كل واحد منا -عاجلاً أم آجلاً- إذا استكنّا وضعفنا في مواجهة هذا الخطر الداهم، وكأننا مكبّلوا الأيدي نكتفي بمطالعة سياط جلادينا.
والمواجهة تبدأ بالوقاية، ولعل أجدى سبل الوقاية هي التوعية والتربية الحسنة، لأن كل أمر مهما كبر تأثيره وخطره،
يكون صغيراً في بدايته يمكن مع ذلك السيطرة عليه ومحاصرته، فنحن عندما نوعّي أبناءنا ونُعرّفهم بخطر المخدرات
على الصحة وعلى العائلة والمال والمستقبل والحاضر، وما ينتج عنه من فقدان للوعي والبصيرة، وما يتفاقم عنها من مشكلات تصل حد الجريمة، نكون قد خطونا الخطوة الأولى في الاتــجاه الصحيح، لأن « الخطوة الأولى لشجرة
الزيتون كي تحيا تكمن في زراعتها « كما تقول الحكمة.
أبناؤنا يستقبلون المجهول ويخرجون إليه ولملاقاته مع تنفّس كل صباح وربما مع سكون كلّ ليلة، وكلّ ما علينا هو أن نجلس معهم، نحاورهم، ونفكّر معهم بصوت عال في هذه القضية الخطيرة، التي تبدأ بسيطة، وربما تنال إعجاب الشباب
في البداية، والحوار هو السبيل لنشر الوعي، « فلم ينتشر الإسلام بالسيف وحده» وهذا يؤكد لنا أن الحوار والتوعية
جزء أساس ورئيس من منظومة العلاج والوقاية، فالشباب والأطفال لا يحتاجون من ذويهم إلى أكثر من الحوار والتوعية بمخاطر المخدرات، وإلا فإن كل أنواع العلاج البعدي لا تجدي شيئا ولا تساوي شيئاً إذا لم كانت التوعية هي الأساس. فهي مشكلاتنا الاجتماعية تتغذى على صمتنا، وتنمو كلما خنقنا أنفسنا وكياناتنا الاجتماعية خلف أسوار العزلة والصمت، وأدوات الاتصال الاجتماعي بعيداً عن مناخات الحوار الأسري.
المخدرات داء يفتك بالمجتمعات، ويعرّض نسيجها للتشرذم، ويعرّض الأفراد للضياع تحت تأثير الإدمان على تعاطي المخدرات التي تزج في النهاية المتعاطي لها في سجون العزلة، والظلمة، وفي أسوار المقابر والمناطق الخربة، في بداية الطريق المجهول ومن ثم إلى سجون العذاب النفسي للمتعاطي وأسرته، ومن ثم إلى عالم من التيه والضياع الاجتماعي والتفكك الأسري والانهيار الاقتصادي للفرد والأسرة. فهؤلاء المتعاطون يشترون الموت، ويغرسونه في أوردتهم وشرايينهم في وقت يحسَبون فيه انهم يشترون الحياة، ونحن في أسرنا نمارس دور المراقب المتفرج العاجز حتى عن الكلام، متناسين أننا إن لم نقم بواجبنا في التوعية والتربية داخل الأسرة، فإن الشوارع والأزقة ستتولى عنا مهمة التربية وعلى طريقة أهلها.
إن نظرة متأملة فاحصة لمآلات هذه الحالة، تكفي لتوقظنا من سباتنا الذي نعيش، فالسمّ الذي يهدوننا إياه ونرسم في ذاكراتنا ومتخيلاتنا صوراً زاهية له، وكأنه البلسم الذي يعالج جراحاتنا أو الهدية التي نستقبلها وتدهشنا أغلفتها ، هو بداية النهاية التي تلج أسوار حياتنا مثل شبح يزرع الرعب في نفوسنا وحياتنا، يخلخل أرادتنا، ويحدث خللاً في توازننا العقلي والنفسي، ويبدأ بعملية هدم الإنسان والمجتمع. هذا السم تَسهُل علينا مواجهته منذ بداية الطريق، لكنه يبدو صعباً كلما تعقدت الأمور وانتشر سرطانه في أجسادنا. والوقاية والتوعية هي خير وسيلة للخلاص منه وتشكيل جدار مناعة ضده عصي على الاختراق، قوامه الوعي والقناعة التامة بأنه ضرر لا نفع فيه. أما بالنسبة للمدمنين الذين باتت سبل النصح والوقاية متأخرة بالنسبة إليهم، ففي الدولة من المؤسسات ما تكفل لهم العلاج، بنيّة الإقلاع، إضافة إلى أن كشفهم عن أنفسهم وعن هذه المشكلة لديهم من شأنه أن يجنبهم العقاب، بل ويحظون بفرص العلاج المجاني، ويمنحون السلطات المعنية الأدلة الكافية لتخليص المجتمع من براثن المدمنين الآخرين ومروجي المخدرات.
المخدرات، طاعون يفتك بالأفراد والمجتمعات،
علينا أن نقف في وجهه صفاً واحداً، بتحصين أنفسنا وأبنائنا بالوعي، وتماسك جبهتنا الأسرية والمجتمعية، ونبذ الخفافيش التي تنشر هذا السمّ، والإبلاغ عنها، لأن هذا السم ليس بمنأى عنا ما دام في جوارنا. فلا يكفي أن أغلق على أبنائي في أسوار المنزل بعد عودتهم من مدارسهم أو أعمالهم ، وكأنهم باتوا في منأى عن هذا الخطر الداهم، بل ينبغي أن نتعاضد في مواجهة شبكات مروجي المخدرات، كل من الحي الذي يسكن فيه، والنافذة التي يطلّ منها.
لعلّ العزلة، وانعدام مناخات الحوار في الأسرة، واستسلام الأب والأم لضغوط الحياة وانشغالاتها، يزرعان بذور انتشار هذه الظاهرة ونموها في قلب المجتمع في حقل من الصمت والاكتفاء بممارسة دور المراقب المتفرج، وكأننا على مسرح ستنتهي فصول مسرحيته في غضون ساعة او ساعتين، متناسين أن هذا الخطر يحدق بكل فرد منا وبكل كيان أسري إذا
لم نقف في وجهه وقفة شجاعة، نعبر من خلالها عن انتمائنا ومواطنتنا، وايماننا بواجبنا في حماية المجتمع والدولة فهل نحن فاعلون ؟!.
عن الرأي
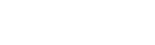





 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس

المفضلات